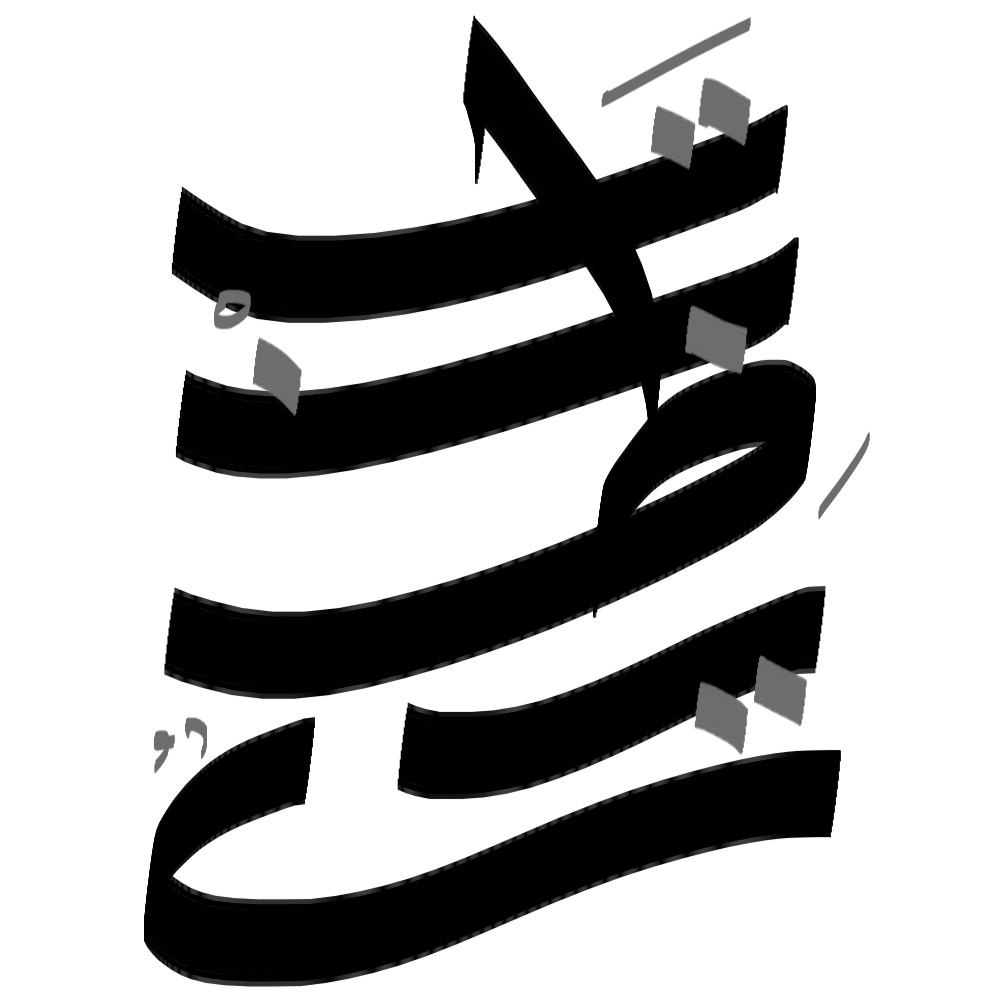يتعلم الأطفال اللغة المنحازة جنسيا في سن مبكرة (هايد، 1984) مما يجعلها عادة لغوية (ليبس، 1997). قد تُستخدم اللغة المنحازة جنسيا لعدة أسباب، منها التقليد، ومنها كون الخطاب المتحيز متأصل ومحفور في المنطوق والمكتوب، مما يصعّب تحديده وتغييره. كما يفتقر الناس إلى معرفة التمظهرات اللغوية للتحيز الجنسي وتحديدها وخاصة المخفية منها. وقد تـ·يعتقد المتحدثون والمتحدثات أنّ ما يشير إليه البعض على أنها لغة متحيزة جنسياً ما هي في الحقيقة إلا لغة عادية. كما يمكن للبعض الآخر أن يستميتوا ويستمتن في إنكار التحيز الجنسي لغة وفعلاً، حماية منهم·ـن للتسلسلات الهرمية الاجتماعية.
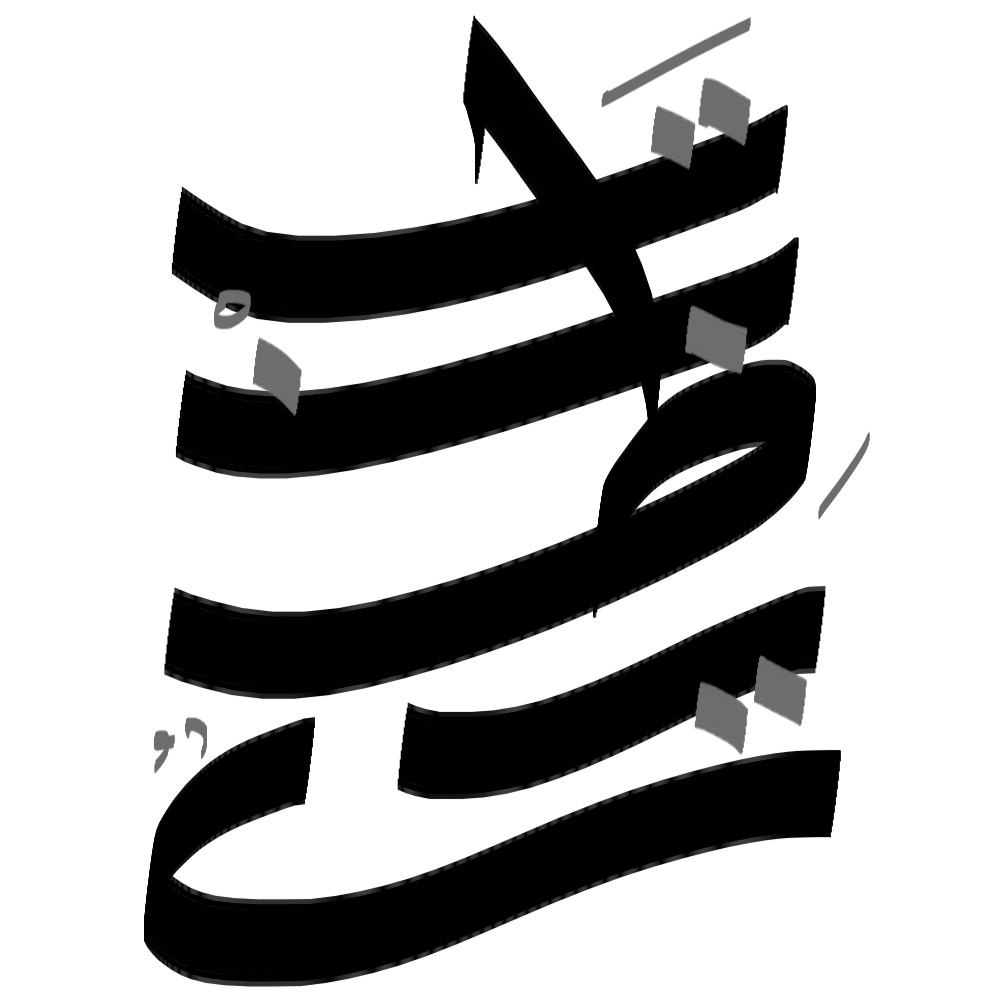
حَوْلَ اسْتِعْمَالِ اللُّغَةِ الشَّامِلَة وَغَيْرِ المنْحَازَة
تصف الدّراسات نوعين من اللّغة غير المنحازة جنسانيا، أولهما "التوازن/التأنيث" وثانيهما "التحييد". ويتطلب الحل الأول، أي التأنيث، استعمال كلمات مراعية لخصوصيات الجنسانية وخاصة في اللّغات التي تتميز بالجندر النحوي، مثل الألمانية والفرنسية والعربية، فيقع إضافة المؤنث إلى جانب المذكّر (مثل استعمال "الصّحفيون والصّحفيات" عوضا عن "الصحفيين" فقط). أما الحلّ الثاني وهو التحييد، فيُستعمل عادة مع اللغات الأقل تنصيصا على الجندر مثل الإنجليزية والسويدية والنرويجية، أين تُستعمل كلمات مثل "الوالدين(parents)" عوضا عن "الأب" (Father) و"الأم" (Mother) و"الإنسانية" Humankind عوضا عن Mankind.
وقد أثبتت الدّراسات أن الاختلاف اللغوي بين التأنيث والتذكير في اللغة يعمق عدم المساواة بين الجنسين. ذلك أن الكلمات التي تحمل صيغة المذكر والتي تُستعمل للاستدلال على الإناث والذكور معا في مفردات مثل "الأطباء" أو "الصحفيين" أو "الأساتذة"، يشجع على الميل إلى الذّكر على مستوى التمثلات العقلية للمتحدثين والمتحدثات. بينما تُحيل الثنائية "الأطباء والطبيبات" و "الصحفيين والصحفيات" أو "الأساتذة والأستاذات" إلى تمثل المرأة في صور إيجابية مع إبراز وجود النساء وتمكينهنّ.
وبما أن اللغة تلعب دورا مهما في التحيز الجنسي، فهل يمكن أن تكون هي نفسها الأداة التي نستعملها لتحقيق العدالة بين الجنسين والتصدي للتصورات التي تميز بين النساء والرجال؟ هل يمكن أن نغيّر الممارسات المتحيزة بتغيير القوالب اللغوية الجاهزة؟
لقد حاز هذا السؤال على اهتمام العديد من الباحثين·ـات عبر العصور، وخاصة بعد أن أثبتت اللسانيات أن اللغة ليست مجرّد مرآة للمجتمع، تعكس اعتقاداته وواقعه فقط، بل هي آلية من الآليات التي تشكل وتصوغ إدراك الأفراد والمجتمع.
في دراسة قامت بها فورمانوفيتش وزملاؤها سنة 2017 عن الجانب الاجتماعي للنّحو، وجدوا ووجدن أن الأفعال، -وهي فئة لغوية أساسية قلّما تغيب عن لغة ما، تحمل بعدا اجتماعيا. إذ أنها تتصل بمفاهيم الوكالة* (Agency). وهو بعد أساسي في المنظور الإجتماعي. وقد وجد فريق البحث أن الأفعال غالبا ما تورد مع الفئات الاجتماعية التي ترتبط بوكالة عالية مثل الرجال والشباب، بينما لا تحظى الفئات الأقل وكالة مثل النساء والمسنين·ـات بنفس المعاملة. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن الأفعال، - وهي الوسيلة النحوية للاستدلال على الحركة، ما هي إلا علامات لغوية للوكالة. وهكذا، تؤكد هذه الدراسة مثل العديد من الدراسات الأخرى، أن اللغة أداة اجتماعية وجزء لا يتجزأ من المنظور الاجتماعي.
كما قامت قوستافسن سندن وزملاؤها سنة 2014 بتحليل 800.000 خبر صحفي نشرته الرويترز بالانجليزية بين سنتي 1996 و1997 وتبيّن أن هذه الأخبار استعملت الضمير المذكر أكثر من الضمير المؤنث. كما أوردت الضمير المذكر في سياقات أكثر إيجابية.
كما قامت جاين توينجي وزملاؤها سنة 2012 بتحليل قاعدة بيانات تتكون من 1.2 مليون كتاب أمريكي نُشرت بين سنتي 1900 و 2008. قامت الدّراسة بتعداد نسبة استعمال ضمائر المذكر والمؤنث فيها ليتبيّن أن نسبة استعمال ضمائر المذكّر بالمقارنة مع ضمائر المؤنث تساوي 3.5 في الفترة بين 1900 و1945. أي لكلّ استعمال واحد لضمائر المؤنّث، نجد استعمالا لضمائر المذكّر يفوقه ثلاث مرّات ونصف. في الفترة بين 1950 و1960 بلغت النّسبة 4.5، بينما تقلصت بعد سنة 1968 لتصل إلى 2، مما يعني أن عدد استعمال ضمائر المذكر تقلص، بينما ازداد عدد استعمال ضمائر المؤنث. وأوزعت هذه الدراسة سبب هذا التباين إلى التغيير الذي حصل على وضعية المرأة في الولايات المتحدة التي شهدت تحسنا ملحوظا مع زيادة إقبالها على التعليم وتبوّئها مناصب رفيعة في الشغل والحياة العامة.
كما قارنت دراسة بايكر (2010) بين 4 مُتون متكونة من نصوص باللغة الانجليزية (البريطانية) في أجناس مختلفة (نصوص صحفية و نثرية وخيالية وأكاديمية) صدرت سنوات 1931، 1961، 1991 و2006. وقد قارنت الدراسة بين هذه المتون في استعمالها لضمائر المؤنث والمذكر، واستعمال كلمات (رجل / امرأة أو بنت / ولد) إلى جانب مهن مجندرة ومناصب مثل رئيس، ناطق رسمي وشرطية، وكذلك كلمات مثل اللّقب أو مصطلح النداء "السّيد" (Mr)، وما يقابلها بالانجليزية (Ms).
وجدت الدراسة أنه وإن تقلص استعمال الضمائر المذكرة، إلا أن هذا التقلص لا يقابله مساواة في التمثيل. وخلصت الدراسة إلى أنه وإن انخفضت بعض القوالب الجنسانية النمطية إلا أن البعض الآخر قد تمت المحافظة عليه. كما تشير هذه الدراسة إلى أن لقب "مِزْ" (Ms) الذي دخل للانجليزية في منتصف القرن العشرين كمرادف لمِستر (Mr)، وكشكل من أشكال الرفض للتمييز الاجتماعي بين الرجال والنساء اعتباراً أن لفظ المناداة مِستر لا يُحيل على الحالة الاجتماعيّة للرّجل، بينما يوجد لفظ "ميس" للآنسات و"مِسيز" للمتزوجات.
وهكذا فرضت المناضلات مبدأ المعاملة بالمثل، ووضعن كلمة "مـِز" كمرادف لـ"مِستر". من المثير أن لفظ "مِـز" وإن وُجد في المتون الأربع إلا أنّ استعماله لم يرقَ لدرجة التخلّص من لفظي "مِس" و"مِسز" ولا لأن يوازي استعماله استعمال كلمة مِستر. فقد وجدت هذه الدراسة أن نسبة استعمال لفظ "مِـز" بلغت 2.7٪ في متن سنة 1991 و10.9٪ في متن سنة 2006. ولعل أهم ما تمّ التّوصّل إليه هو أن لفظ "مِستر" قد تراجع استعماله بطريقة ملحوظة، مما يغيّر سؤال الدراسة من : هل يتساوى لفظ "مِـز" مع لفظ "مِستر" ؟ إلى هل سنواصل استعمال الألقاب والمسميات الاجتماعية في اللغة الانجليزية أساسا؟ وهل ستندثر كلمة مِستر من اللغة في غضون الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة؟
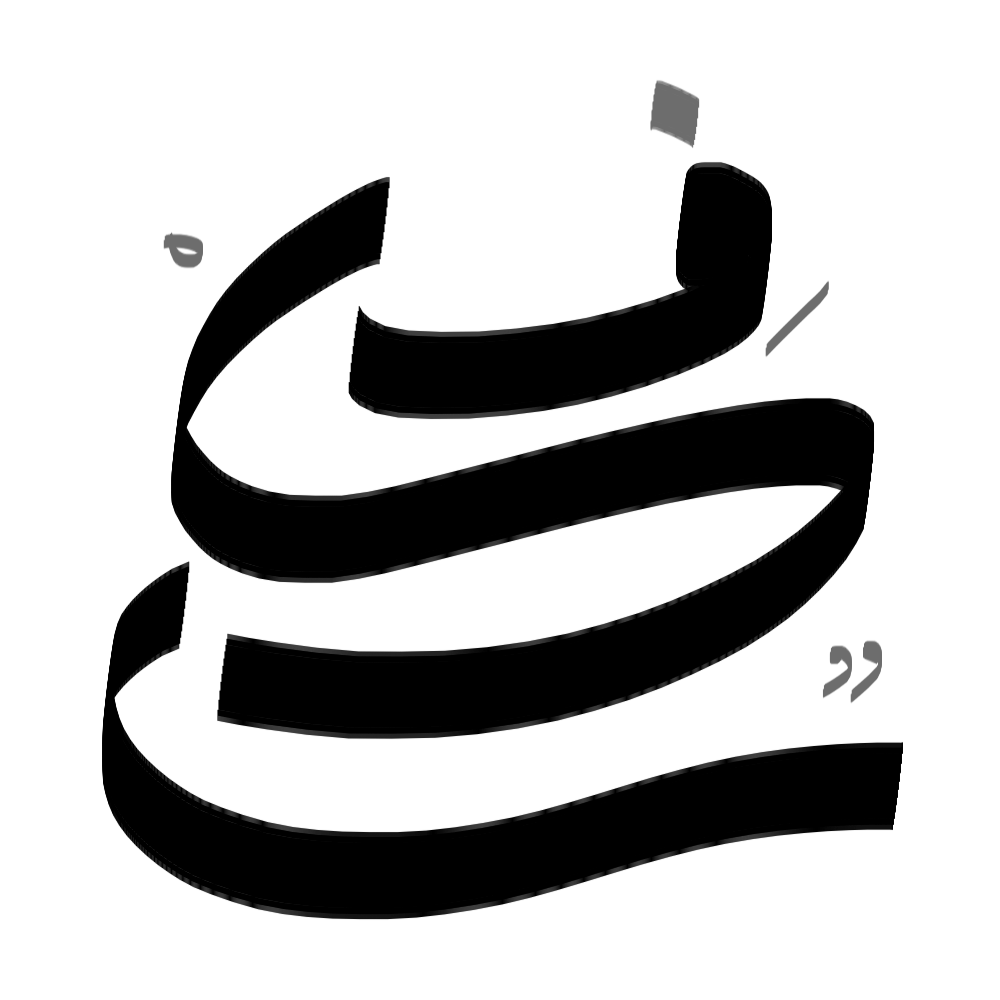
شهدت العديد من البلدان، خلال السنوات الماضية، تحولًا ثقافيًا في مصطلحات النوع الاجتماعي عند استخدام اللغة. فانخفض، على سبيل المثال، استخدام ضمائر المذكر العامة مثل هو، وهم، انخفاضا كبيرا في الكتب المنشورة باللغة الإنجليزية خلال القرن العشرين. كما انخفض تواتر استعمال هذه الضمائر في الكلام المنطوق في أستراليا خلال الستينات والتسعينات من القرن الماضي، وخاصة في البرامج الإذاعية والمناقشات البرلمانية (باولز، 2003).
أتى هذا التحول نحو لغة شاملة جنسانيا نتيجة لتظافر جهود الجمعيات والحكومات التي أكدت على ضرورة الابتعاد عن اللغة المتحيزة جنسيا وتبني اللغة الشاملة، ونذكر هنا على سبيل المثال المبادئ التوجيهية في سبيل صياغة شاملة جنسانيا باللغة العربية الصادرة عن الأمم المتحدة أو مبادئ الجمعية الأمريكية لعلم النفس. وبعيدا عن الالزام الحكومي أو الأممي أو المدني لاستعمال لغة مجندرة وشاملة، لا يزال للمتحدثين والمتحدّثات حرية الاختيار بين رفض قواعد الجندرة في أحاديثهم·ـن العفوية وبين احترامها.
ولعله يجدر بنا هنا أن نتوقف قليلا عند مفهوم التمثلات. تعرف نظرية التمثلات الاجتماعية هذا المفهوم على أنه متصل بالإدراك والمعرفة بالرغم أن كلمة التمثلات تُستعمل أحيانا على أنها ظواهر ثقافية، تعين الأشخاص على فهم ما حولهم·ـن. من جهته، يعرف علم النفس الاستطرادي أو الخطابي هذه التمثّلات على أنها تكوين استطرادي (خطابي) يبنيه الأشخاص من خلال الأحاديث والنصوص. ويرتكز علم النفس الاستطرادي على كيفية بناء التمثلات (قوية ومستندة للواقع) وعلى كيفية استعمالها وتوجيهها نحو الأفعال (مثل توجيه اللوم، أو توجيه الدعوات وغيره). ويقع التعامل مع التمثلات مثلما يقع إنتاجها وأداؤها وبنائها، بالضبط كما هي، للقيام بأدوارها في الأنشطة. ولهذا يتعامل علماء النفس الاستطرادي مع النشاط كعنصر أساسي ومفتاح لفهم التمثلات.
وإن تؤيد نتائج البحث أن استعمال الثنائيات يزيد من المساواة بين الجنسين، كثيرا ما تلقى دعوات استعمال لغة مجندرة وغير منحازة العديد من ردود الفعل السلبية وحتى العنيفة. في سنة 2012، حاولت السويد إدخال ضمير ثالث بالإضافة إلى ضمير المؤنث وضمير المذكر، ليكون الضمير الثالث محايدا يمكن استعماله في حالات لا يكون فيها الجندر معلوما أو غير ذي أهمية أو للأشخاص خارج التّصنيفات الجنسانيّة الثنائية، ولم تقم لغة أخرى بالإضافة للغة السويدية باضافة ضمير ثالث، مما يجعل حال السّويد فريدا من نوعه.
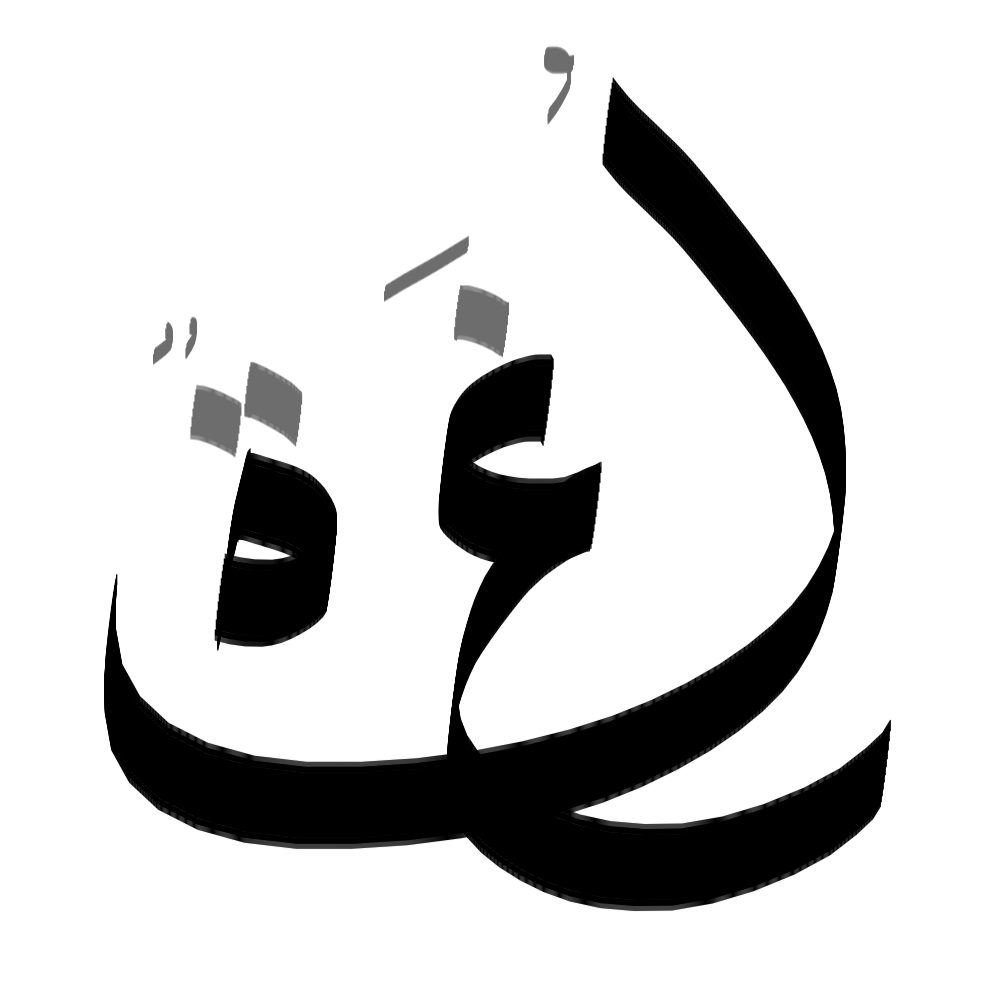
نَحْوَ لُغَة عَرَبِيَّة شَامِلَة: تَــجْرِبَة إِنكِفَاضَة
انطلقت إنكفاضة في استعمال كتابة عربيّة شاملة في البداية مستندة إلى محاولات لغويّة فرديّة انبثقت خاصّة صُلب الأوساط النّسويّة والنّضاليّة العربية على وسائل التّواصل الإجتماعي. كانت هذه المحاولات الأولى تقوم أساسا على الجمع بين المُذكّر والمؤنّث في ثنائيّة مفصولة برمز "/".
يفترض استعمال الرّمز "/" من القارئ·ـة فصل كلمة "التونسيّين/ات" إلى "التّونسيّين والتّونسيّات" خلال القراءة، أي تعويض علامات الإعراب الخاصّة بالمذكّر بتلك الخاصّة بالمؤنّث، ذهنيّا وآليّا. غير أنّ الطّبيعة المجندرة للغاية للّغة العربيّة فرضت استعمالا متكرّرا ومُفرطا لرمز "/"، ما قد يضرّ بالقراءة المتسلسلة، وبالإستطيقا الخاصّة باللّغة العربيّة ذات الحروف المتّصلة.
تستند المرحلة الثّالثة والأخيرة في الكتابة العربية الشّاملة التي تعتمدها إنكفاضة على فصل علامات إعراب المذكّر عن تلك الخاصّة بالمؤنّث بنقطة متوسّطة (·) في نفس الكلمة، أكان اسما أو فعلا صحيحا أو جمعا سالما أو مركّبا... هذا الاستعمال للنّقطة المتوسّطة لا يكون كافيا مع الأفعال المعتلّة و جمع التّكسير وغيره. لذا، تمّ إدراج المعطوفات للجمع غير التّفاضلي بين المؤنّث والمذكّر وكأداة لغويّة عربيّة الأصل، خفيفة القراءة على اللّسان العربيّ، نجد أمثلة على استعمالها في آيات قرآنيّة من قبيل الآية 35 من سورة الأحزاب ۞إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۞
الفُرَصُ وَالعَرَاقِيلُ أَمَامَ لُغَة عَرَبِيَّة شَامِلَة
كما تبيّن سابقا في هذه الدراسة، لا تحتوي اللغة على سلطة كامنة فيها، بل تستمد سلطتها أساسا من المتحدثين، كما أن اللسانيات لا تصنف اللغات على أي أساس قيمي. فليس هنالك في اللسانيات معايير جمال الغة أو الصعوبة أو التعقيد. ولذلك فليس هنالك علميا لغة تستطيع أن تكون شاملة وغير متحيزة وأخرى لا، أو أنه يستحيل تحويل أي لغة من متحيزة إلى منصفة. ولذلك فيجب على متحدثي·ـات العربية التّفكير في الطرق المُثلى للتأسيس للغة شاملة ومنصفة بعيدا عن التحيز الجنسي.
يتطلب التفكير في لغة عربية شاملة مراجعة النقاط التالية:
أولا: هل يمكن التفكير في لغة عربية شاملة واحدة مع كل الاختلافات الجندرية المترسبة في ثقافة كل بلد عربي على حدة؟ كيف يمكن أن نحصل على لغة شاملة تكون فضفاضة بما يكفي حتى تعم على كل مستعمليها ومستعملاتها من الخليج إلى المحيط، حاملة في نفس الوقت ما يكفي
من الخصوصيات التي تميزها عن الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية؟
ثانيا: هل يمكننا نقل اللغة الشاملة عن اللغات الأخرى؟ أم سنكتفي بنقلها عن الإنجليزية وهي اللغة التي كُتبت بها أهم الدراسات الجندرية سواءً في اللسانيات الاجتماعية أو في الدراسات النسوية أو في السياسة أو علم النفس أو العلوم السياسية؟ هل سنكتفي بريادة
الدراسات النسوية في البلدان الانجلوسكسونية، أم أننا سننقل تطورات اللغة الشاملة عن ثقافات أخرى؟
ثالثا: هل يمكن أن نفكر في الرجوع الى الإرث العربي الإسلامي بما أنه قد تبين أن الثنائية الجنسية خاصية الثقافة الغربية أكثر من غيرها؟
رابعا: هل نحتاج أن نأسس لترجمات نسوية لدراسات الجندر؟
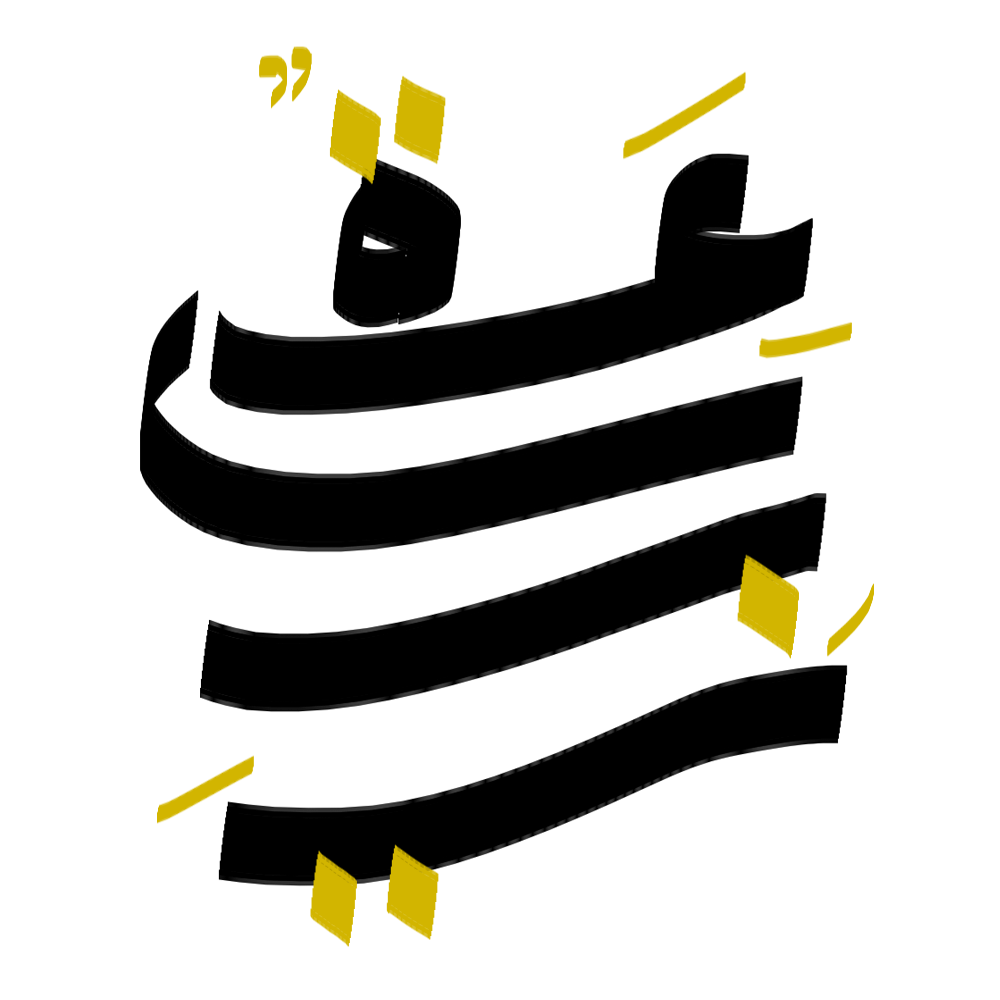
من المؤكد أن يقابل المحافظون على العربية أي محاولات لتغييرها بالتشكيك والصدّ لأسباب عديدة ذكرنا بعضها في الجزء الخاص باللغة العربية ومنها حالة الديقلوسيا التي تشهد فروقا متنامية بين المنطوق والمكتوب. وقد أثبتت بعض التجارب لتقليص اللغة المتحيزة في الانجليزية مثلا ما يلي:
- يبتعد المتحدثون عن الكلمات المسيئة للنساء بطريقة عفوية كلما تمّ التفطّن لذلك.
- إذا ما اضطرّت لغة ما أن تنحت كلمة جديدة أو تعبيراً ما، فمن المستحسن أن تفكر في الكلمات التي تبدو طبيعية وتستند على كلمات أو تعابير موجودة.
- من المحتمل أن تـ·يقابل المتحدثون·ـات الكلمات الجديدة تماما بالتشكيك والصد.
ذكرنا سابقا أن اللسانيات الكويرية لم تجد طريقها إلى اللغة الألمانية أو الفرنسية على سبيل المثال لأسباب عديدة، منها صعوبة ترجمة كلمة كْوير، ولكن كذلك بسبب رفض ما اعتبره بعض اللسانيّين هيمنة للثقافة الأنجلوسكسونية وإمبريالية اللّغة الانجليزية.
تساءل بيار بورديو كذلك عن كيفية مجابهة إفراط السلطة المتأصل في الهيمنة اللغوية؟ وأردف قائلا "يجب أن نفكر في هذا النموذج وأن نجد طريقة لمواصلة استعمال الانجليزية من دون التعرض لخطر الانغماس فيها وفي هياكلها المفاهيمية من دون أن تغسل أدمغتنا بأنماطها اللغوية".
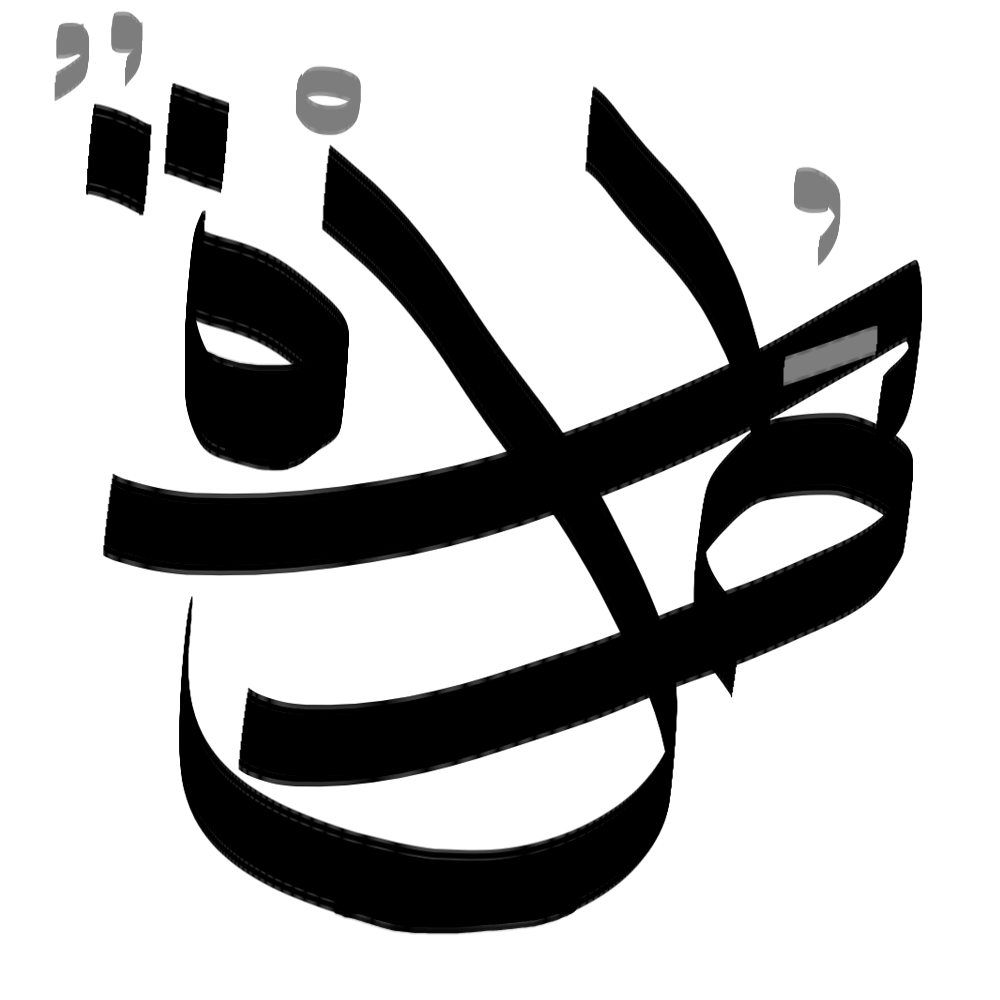
يمكن للترجمة أن تكون أداة أساسية للنضال الاجتماعي من أجل الهيمنة وهذا أحد أنواع عنف الترجمة. ونظرًا لصراع الثّقافات الدائم على السلطة، يمكن للمترجمين·ـات ترجمة نصوص ونشرها لتقويض أو مقاومة الثقافة أو المجموعة "الأخرى". وقد تناول ألفاريز وفيدال (1996) هذا الهدف المحدّد من الترجمة واقترحا أن الترجمة ما هي إلا "عملية معقدة لإعادة الكتابة تتم بالتوازي مع النظرة العامة للغة "والآخر" عبر التاريخ، والتأثيرات وتوازنات القوى الموجودة بين ثقافة وأخرى". وعلى الرغم من أنّهما لم يستخدما مصطلح "العنف"، إلا أنهما بيّنا كيف يقوم اللاعبون الرئيسيون، وهم المترجمون التحريريّون والفوريون، بوعي أو بغير وعي، بتعديل النصوص لتتناسب مع مصالح مجموعتهم. وقد تـ·يقرر المترجم·ـة، بوعي أو بغير وعي، الدخول في الجدل حول الخطاب الذي تـ·يترجمه متأثراً·ةً بالرواية العامة ومفضلاً·ـةً أن تـ·يكون جزءا من الصراع على السلطة بعد أن فشل·ـت في التحكم في عزل نفسه·ـا عن التورط في هذا الصراع. هذا هو النوع من العنف الذي يشير إليه بيار بورديو على أنه عنف "رمزي".
يرى (فنوتي 1996) أن المترجم·ـة تـ·يسلط عنفا على النص عندما تـ·يحاول توطينه في اللّغة والثقافة المقابلتين ليزيد أو تزيد من حسن مقروئيّته وسهولة قبوله عند القارئ·ـة. وقد أشار إلى هذه الظّاهرة بقوله "التعصب الثقافي". حيث تـ·يبتغي المترجم·ـة من ذلك ألا تـ·يشعر قارئ·ـة النص المترجم بثقل الترجمة و"ركاكتها"، ولا حتى كون النص الذي أمامه·ـا مترجم. وهنا تـ·يتصرف المُترجم·ـة عبر الحذف والتغيير والاسقاط فيما تـ·يراه غير مقبول في اللغة المقابلة. ولذلك يعارض فنوتي "بناء النص الأجنبي وفقًا للقيم والمعتقدات والتمثيلات الموجودة مسبقًا في اللّغة الهدف". مما يعني أنه كلما انغمس النص المترجم في اللغة والثقافة الهدف كلما زاد عنف الترجمة.
ولعلنا سنحتاج إلى تراجم نسوية لنتمكن من إنشاء لغة شاملة، وقد نحتاج إلى مترجمات متشبعات بالنظرية النسوية حتى يتمكّنَّ من سدّ فراغ الأيديولوجيا إذا ما وُجد وإيجاد المرادف المناسب في العربية سواء عن طريق الاسترداد أو الاقتراض أو النحت.